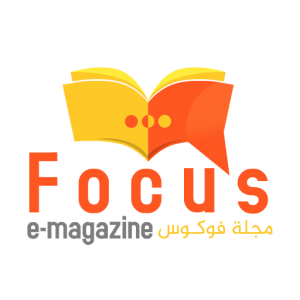رواية “حَصَّادُ الرّمال” لمحمد ساري
شهدت العشرية السوداء في الجزائر مآسي كبيرة وآلام عظيمة تكبّد خسارتها الشّعب الجزائري، مهّده مشروع بناء “دولة إسلامية”، وكأنّ شعبها تائه عن دينه وملّته، وأوهم مُروّجوه التابعين بأنّهم “جنود الله” على هذه الأرض، لكن هل كانوا واعين بانخراطهم في هذا الخراب؟
“تبًا لتلك الأحلام التّي هيّجتنا وأوهمتنا بقُدراتنا على إنجاز المُعجزات، وأنّنا جنود الله في هذا العصر الموبوء، الذّين سيعيدون مجد الخلافة الإسلامية الضّائعة. لماذا خيّب الله مسعانا؟ ألم نُعدّ العُدّة اللازمة لهذا المشروع العظيم؟ ألم يحن بعد وقت استرجاع هذه الخلافة؟ ماذا حدث لنا حتّى أُصبنا بتلك الانتكاسة المُخجلة، فوجدنا أنفسنا مدحورين، مُستسلمين، لا حُلم لنا إلاّ النّجاة بجلودنا، أين تلك الوعود بالشّهادة التّي تُمهّد الطّريق إلى الفردوس الأبدي؟ أين تلك العزيمة المُتأجّجة فينا بأن نُثابر ونُقاتل حتّى النّصر أو الشّهادة؟”، يتساءل “محمد ساري” على لسان بطل روايته “حَصَّادُ الرّمال”.
“حَصَّادُ الرّمال”

نُشرت رواية “حَصَّادُ الرّمال” لـ “محمد ساري” في شهر جانفي/كانون الثاني سنة 2022 عن دار نشر “الحبر” الجزائرية. الرّواية كانت مُرشحة ضمن القائمة الطويلة لجائزة “آسيا جبّار” الكُبرى، في دورتها السّادسة لسنة 2022 لفرع الرّواية المكتوبة باللّغة العربية.
وتسرد الرّواية قصة شاب إرهابي يُدعى “فيصل بُوسَكّين” ويُلقّب بـ “الأفغاني” يستجيب لنداء قانون الوئام المدني الذّي أطلقه الرّئيس الرّاحل “عبد العزيز بوتفليقة”. هذا الأمير الذّي كان يُرعب قوات العسكر في الجبال، ها هو يستسلم بعدما خابت كل آماله في جهاد لا أساس له بالمرة. ويعود إلى مسقط رأسه بقرية “عين الكرمة” وهو عازم على استرداد أموال إتاوة الجهاد التّي تركها له رفيقه في الحرب وديعة عند أخٍ له، ولكن هل سيتمكّن “فيصل بُوسَكّين” من استرجاع هذه الأموال أم أنّ القدر يهيئ له مصيرًا آخر؟ أضف إلى ذلك، فإنّ يدي “فيصل بوسكّين” مُلطّختان بالدّماء، إذ يُقال إنّه قتل أحد أبناء قريته “سليم” ابن السّبتي” ووالد الضّحية عازم كلّ العزم على الانتقام لابنه، فماذا سيحدث يا تُرى؟
“محمد ساري”
“محمد ساري”، هو روائي وناقد ومُترجم جزائري، وأستاذ النقد الأدبي (سيميولوجيا، سوسيولوجيا، وتحليل الخطاب) ونظرية الأدب بجامعة الجزائر “2”، من مواليد 1958/02/01 بمدينة شرشال، ولاية تيبازة، يكتب باللّغتين العربية والفرنسية.
وترأس الأستاذ “محمد ساري” لجنات عديدة منها:
- رئيس لجنة الإبداع والترجمة في المركز الوطني للكتاب منذ تأسيسه في سنة 2013 إلى غاية ديسمبر/كانون الأول من سنة 2020؛
- رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب من جوان/حزيران من سنة 2020 إلى غاية جويلية/تموز من سنة 2021 (نهاية العهدة)؛
- رئيس لجنة التحكيم لجائزة “محمد ديب” للرواية (2016 – 2020)، وعضو في لجنة التحكيم لجائزة آسيا جبار للرواية (الدورة الأولى 2015).
كما أطّر ورشة للترجمة في سنة 2016 في المعهد العالمي للترجمة الأدبية بأرل/فرنسا (تخصّص فرنسي/عربي- عربي/فرنسي).
نشر العديد من الكتب في النقد الأدبي، ونذكر:
- “البحث عن النقد الأبي الجديد”، عن دار الحداثة اللبنانية، سنة 1984؛
- “محنة الكتابة”، عن منشورات البرزخ الجزائرية، سنة 2007؛
- “في معرفة النص الروائي (دراسات نقدية بين النظري والتطبيقي)”، عن دار أسامة الجزائرية، سنة 2009؛
- “الأدب والمجتمع”، عن دار الأمل الجزائرية، سنة 2009؛
- “وقفات في الفكر والأدب والنقد”، عن دار التنوير الجزائرية، سنة 2013؛
- “في النقد الأدبي الحديث”، عن مقامات للنشر والتوزيع الجزائرية، سنة 2013.
ونشر روايات عديدة، منها المكتوبة باللغة العربية، ونذكر:
- “السّعير”، عن دار “لافوميك” الجزائرية، سنة 1986، وأثارت الرّواية ضجة على الساحة الأدبية الجزائرية؛
- “على جبال الظهرة”، عن المؤسسة الوطنية للكتاب، سنة 1988 (وقد نالت هذه الرواية الجائزة الثالثة في المسابقة الأدبية للرواية التي نظمتها وزارة الثقافة بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال سنة 1982، ونشرت ضمن نصوص المسابقة في عدد خاص بمجلة أمال سنة 1983)؛
- “البطاقة السّحرية”، عن منشورات الاتحاد الكتاب العرب السورية، سنة 1997، وهي رواية كُتبت على طريقة الكاتب الكولومبي “غابريال غارثيا ماركيث”.
- “الورم”، عن منشورات “الاختلاف” الجزائرية، سنة 2002؛
- “الغيث”، عن منشورات “البرزخ” الجزائرية، سنة 2007، وأُعيد نشرها في طبعة مزيدة ومنقحة سنة 2019 بدار الشهاب الجزائرية؛
- “القلاع المُتآكلة”، عن منشورات “البرزخ” الجزائرية، سنة 2013؛
- “حكاية أسفار”، عن دار “أناب” (ANEP) الجزائرية، سنة 2016؛
- “حرب القُبور”، عن منشورات “الجزائر تقرأ” الجزائرية، سنة 2018؛
- “نيران وادي عيزر”، عن دار “العين” المصرية، سنة 2022؛
- “جسدي المُستباح”، وهي رواية تحت الطبع، ومن المزمع صدورها خلال خريف 2022.
وروايات باللّغة الفرنسية، منها:
- «Le labyrinthe» (المتاهة)، عن دار “مارسا” الفرنسية (Editions Marsa)، سنة 2000؛
- «Méprise fatale» (احتقار مُهلك)، عن منشورات “ميتيلييه” الفرنسية (Editions Métailié)، سنة 2005؛
- «Pluies d’or» (أمطار من ذهب)، عن دار شهاب الجزائرية، سنة 2015 (وحصدت الرواية “جائزة إيسكال الأدبية” بالجزائر سنة 2016)؛
- «Aizer: un enfant dans la guerre» (عيزر: طفل في الحرب)، عن منشورات البرزخ الجزائرية، سنة 2018.
كما ترجم إلى اللّغة العربية روايات عديدة لـ “محمد ديب” و”مالك حدّاد” و”ياسمينة خضرا” و”بوعلام صنصال” و”مايسة باي” و”أنور بن مالك” و”مليكة مقدّم” و”عيسى خلادي” و”سليم باشي” و”حميد سكيف” و”جمال سويدي” و”رشيد بوجدرة” ومُذكرات المجاهدة “زهرة ظريف” والمجاهد “عمار قرفي”، وغيرهم.
عين الكرمة…
خرج المُصلون من مسجد قرية “عين الكرمة” بعد أداء صلاة المغرب، واقترب “حميد عفيان” (أو كما يُلّقبه القُرويون بـ “حميد نيوز” لأنّه يجلب كلّ أخبار القرية) من صديقه “ناصر بولعراج”، وعليه سمات الحذر لعلّه يخبره بسرّ كبير.
علم “ناصر بولعراج” منه بأنّ “فيصل بوسكّين” المدعو “الأفغاني” عاد إلى “عين الكرمة”، لقد رآه وهو ينزل من الحافلة حليق الذّقن يرتدي ملابس قديمة وعلى رأسه قُلنسوة، هذا “الأفغاني، الحلّوف، القتّال” عاد أخيرًا بعدما شيع عنه أنّه قُتل منذ عامين.
لماذا عاد؟ بل كيف تجرّأ ودخل القرية؟ أنسي أنّه قتل “سليم” ابن الشّيخ “السّبتي”؟ والده أقسم بأنّه سيأخذ بثأر ابنه. يقولون إنّه لا توجد أدلة على ذلك، فابن “السّبتي” قُتل على أيدي جماعة من الرّجال المُسلّحين المُلثّمين بعدما أوقفوا سيارة أجرة وأنزلوه منها.
“سليم” هو أخ زوجة “ناصر” وهو يتذكّر تلك الفاجعة، في تلك الفترة، كان يؤدّي واجبه العسكري في “الخدمة الوطنية” ونجا من قبضة الإرهابيين فهو أُرسل إلى الصحراء في الناحية الرّابعة، على الحدود اللّيبية.
“صحيحٌ أنّ التّهريب هناك ضرب أطنانه وأزهرت مشاتله: المالبورو، الويسكي، الحشيش، الذّهب، الملابس المُستوردة، المواد الغذائية، وكثير من الضّباط اغتنوا باقتطاع نِسَبٍ مُعتبرة لإعادة بيعها في السّوق السّوداء، أنا نفسي استفدتُ مرّة بسروالين جينز وجاكيتة جلدية ما زلتُ أحتفظ بها إلى الآن. أوقفت مِفرزتنا شاحنة غاصة بالألبسة، فطلب منّا النّقيب أن نختار منها ما أعجبنا من ملابس، فلم نتردّد… الغنائم كثيرة، والكُلّ يغرف منها بسخاء، قبل أن تُسجّل السّلع المُتبقية وتُرسل إلى القيادة بورقلة (…) ولكن عُمومًا كُنّا مُرتاحين، أكل، شرب ونوم، وقليل جدًا من المُطارادات”، قال “ناصر” (ص 13).
لقد مرت عشر سنوات من الخراب، وسالت الكثير من الدّماء ودخل البلد في حرب أخوية “أكلت الأخضر قبل اليابس”، ربّما مع مجيء الرّئيس الجديد، سيعرف البلد الاستقرار.
انتفض “حميد نيوز” وقال: “الرّئيس الجديد! رؤساؤنا لا يعرفون إلاّ الكلام الفارغ والوعود الكاذبة، لن يختلف هذا عن الذّين سبقوه. ها هو يقلّدهم، يسكن في التلفزة ، يُمطرنا عند كلّ ثامنة بخطب معسولة، كما لو أنّنا سنتعشّى بها. في المُقابل، لا شيء… لا عمل، ولا إنجازات عظيمة، ولا سهّلوا علينا الهَرْبَة… ما بقي لنا غير البُوطي، لعلّه يطير بنا إلى فردوس فافا… أو يأكلنا الحوت ونرتاح من هذه العيشة المُرّة…” (ص 15).
ردّ عليه “ناصر” قائلاً: “هذه أرضُنا وبلادنا، رمانا إليها قدرنا، فما علينا إلاّ أن نتدبّر عيشنا فيها… كيف عاش أجدادنا؟ أنَحن خيرٌ منهم؟ كيما يقول المثل: بَرْوِيطَة في بلادي خير من طيارة في بلاد النّاس” (ص 16).
“الأفغاني” و”عبد الجليل”
وصل “فيصل بوسكّين” إلى “عين الكرمة” سيتوجّه إلى بيت “مصطفى” لا يدري إن كان سيتذكّره. “مصطفى” هو أخو “عبد الجليل” رفيق الحرب في الجبل لقد حملا السّلاح معًا ضدّ الدّولة أو كما يطلق عليها الإرهابيون اسم “الطّاغوت”، ولكن مات “عبد الجليل” بينما هو سلّم نفسه ليستفيد من العفو الشامل الذّي أقرّه الرئيس الجديد.
“عبد الجليل” كان “ذراعه الأيمن ومُؤتمنَ أسراره أيام كان أميرًا تلهج الأصوات بالثناء على جبروته المُحبّب وقسوته المُستساغة، أيام كان قائد جماعة إسلامية مُسلّحة، حطّ أفرادها، أو ما تبقى منها، السلاح وسلّموا أنفسهم لقوات الجيش، مُستفيدين من العفو العام، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، تلك الحرب التّي كانت ستُغيّر وجه العالم لو تقدّر أن كان هو المنتصر. وقد آمن واقتنع لسنوات أنّه سيكون المُنتصر حتمًا. ولكن هيهات!” (ص 21).
“الأفغاني”، يريد أن يسترجع من “مصطفى” أمواله، إنّها أموال إتاوة الجهاد، كما يُسمّونها، حيث كانوا يجمعونها من عند سكان الأرياف أو من الذّين كانوا يستوقفونهم عند الحواجز المُزيّفة.
كان “عبد الجليل” طالب بجامعة “البليدة” تخصّص في الهندسة الالكترونية ولم يكن مُنجذبًا نحو الجوّ الجامعي “حتّى جرفته موجة الغضب الطّلابي. انساق خلفها بعفوية، رأى فيها انسجامًا مع نواميس تنشئته الدينية الطبيعية المُحافظة، أغواه خطاب أولئك الفتيان الذّين يرفلون في جلابيبهم البيضاء، مُحصّنين أنفسهم خلف شرعية تمثيل تاريخ يعود إلى قرون خلت، مجدّوه وقدّسوه وحوّلوه إلى جنّة عدن، وقد أخذوا على عاتقهم إحياء كما كان، بل وأحسن، فوجد الفتى الغرّ نفسه تلقائيًا، باندفاع عاطفي مُنقطع النّظير، دون حسابات من أيّ نوع، ينخرط في صفوفها ويُشارك في المُظاهرات والإضرابات المُتواترة، يوزّع المناشير والدّفاتر والجرائد الحزبية الدّعائية ويُعلّق المُلصقات على الجدران ويحضر التّجمعات والحلقات المُصغرة داخل الغرف الطُلابية، بخجل وتردّد في البداية، قبل أن يكتشف مخزونه الخفيّ في القدرة على التّدخل وسط الجمع الغفير من المُستمعين والتّعبير عن أفكاره بسلاسة لغوية لفتت أنظار قواد الحركة، فقرّبوه إليهم وتجلّوا خصاله وأشركوه في جلسائهم السّرية، حتّى صار واحدًا من القياديين المعروفين” (ص 23).
المُتشدّدون
أخذ “ناصر بولعراج” يستعيد ذكريات قديمة عن تلك الفترة السوداء، إنّه يتذكّر جيدًا “فيصل بوسكّين” وانضمامه إلى الجماعات المُتشدّدة، هو نفسه تعاطف معهم.
لقد “وجد نفسه كغيره من أغلبية أقرانه، يندفع بحماس لا نظير له خلف نشاطات الأحزاب النّاشئة والتّي سمّت نفسها ~إسلامية~ وزعمت استعادة مجده المُلوّث بالأفكار الواردة من الغرب (…) وجد نفسه في دوّامة المُناصرين لأنبياء لا يدري أحد من أيّ رحم مَرقوا فجأة، أمِن أعماق الأرض أم من سُدُم السّماوات، يملون عليهم تعاليم الدّين الجديد. كلّ يوم إلا ويأتي من يأمرهم بسلك درب غير الدّروب المعلومة. وكان المُناصرون يتكاثرون بأعداد الجراد الزّاحف على الأقاليم الخضراء المُثمرة، وقلوبهم تمتلئ فخرًا وإيمانًا بأنّ حدثًا تاريخيًا عظيمًا على أهبة الحدوث، ولم يكن أحد يريد البقاء على الهامش. فاندفع ناصر كطفل أغرَته ألعاب سحرية، ورمى بنفسه وسط الحلبة بلجّة وضجّة دون أدنى تفكير. كان بطالاً أيامها ووجد تسلية ألهته عن غمّ العوز وأبعدته عن لوم أبويه وحثّهم الدّائم والمُتكرّر ليبحث لنفسه عن شغب يقيه من مُفاجآت الحياة وهو المُقبل عليها فارغ اليدين. الجميل والمُربح في شغله الجديد أنّه لا يدفع دينارًا واحدًا من جيوبه الفارغة ” (ص 44-45).
وهكذا بدأ يشارك “ناصر بولعراج” في التّجمعات والمسيرات التّي كان يُنظمها المُتشدّدون ويوزّعون المناشير والجرائد والسندويتشات على النّاس ويرفعون اليافطات والرّايات خلال المسيرات. وأخذ يساعدهم في أعمالهم وجمع الأموال في المساجد بين صفوف المُصلّين. لكنّه أدرك بعد وقت وجيز أنّ الأموال التّي جُمعت لم تكن تُسلّم للمُحتاجين والفقراء بل كانت تذهب إلى جيوب المُسيّرين، وهكذا أصبح يراهم يرتدون ألبسة وأحذية ماركة من صناعة الغرب، أمّا هو فبقي في جلابته البالية التّي اقتناها من سوق “بومعطي” بالحراش.
وفي أحد الأيام بعد عملية جمع الأموال في مسجد القرية، كما جرت العادة، اقترح “ناصر” على المُسيّرين أن يُعدّ معهم الأموال، انتفض قائدهم وهو “فيصل بوسكّين” ووبخّه لأنّه فهم أنّه يشكّ فيهم فتمّ إعفائه من القيام بجمع الأموال في المسجد وأخذوا يعزلونه شيئًا فشيئًا، ومنذ تلك الحادثة ابتعد “ناصر” عن جماعة المُتشدّدين.
“مصطفى” أخو “عبد الجليل”
وصل “فيصل بوسكّين” ليلاً إلى بيت “مصطفى”، ربّما لن يتذكّره هذا الأخير، وبالفعل عندما فتح “مصطفى” الباب لم يعرف الغريب الذّي يقف أمامه فذكّره “فيصل” بأنّه جاء مع أخيه “عبد الجليل” وأودعا عنده الأموال التّي جمعاها، حينها عادت الذّاكرة إلى “مصطفى” وانتابه الهلع فهو كان يعتقد بأنّ “فيصل بوسكّين” هلك في الجبل مع أخيه، كما أنّ ثلاثة أرباع من الأموال استثمرها في تجارته فكيف له أن يخرج من هذا المأزق؟
يُدرك “مصطفى” جيدًا أنّه إن صارحه بالحقيقة ستكون النتيجة وخيمة وربّما يجهز عليه، فـ “فيصل” ليس أيّ شخص كان، إنّ له ماضٍ إرهابي، ولن يصعُب عليه قتله. خمّن “مصطفى” لحظات وقال له إنّ أمواله محفوظة واقترح عليه أن يكون شريكه في التّجارة ودعاه للمبيت عنده في اللّيل حتّى يحين الصّباح.
“شكّ فيصل أنّ في الأمر فخًا ما، لماذا يُماطله؟ لماذا لا يسلّم له نصيبه فورًا؟ هذا معناه أنّه صرف الأموال، خان الأمانة. الدّليل تلك الشّاحنة المركونة، تُساوي الملايين… وذلك السّور واللّه أعلم ماذا يخفي وراءه. تدفقت على ذهنه أفكار مُشتّتة. فكرة الشّراكة مُغرية. وهو لا يعرف شيئًا عن التّجارة ومصطفى هذا خبير بشهادة أخيه، المسامير الصدئة ويجد لها مُشترين! لم يتبادر إلى ذهنه الجواب اللّائق الذّي يردّ به على اقتراح غريمه الخطير (ص 58).
بعد صمت طويل، قبل “فيصل” اقتراح “مصطفى” ولو أنه لم يرتح له.
اللّقاء مع العائلة
بعد مغادرته في اليوم الموالي من عند “مصطفى”، انطلق “فيصل بوسكّين” نحو بيت عائلته، البيت عبارة عن كوخ قصديري من بين الأكواخ القصديرية المُتواجدة في القرية. عندما دخل الحوش، خرج والده، لقد تغيّرت ملامحه كُلّها وشاخ أكثر فأكثر يبدو أنّه لم يتعرّف عليه، وأخبره “فيصل” بأنّه عاد إليهم أخيرًا، ابتهج والده وأدخله البيت.
ظهرت والدته تسعل وهي مُنهكة القوى، وذُعر “فيصل” لرؤيتها، لم يكن يعتقد أن يراها في تلك الحالة الصّحية المُتدهورة. أخبراه أنّه بعد انضمامه إلى الجماعات الإرهابية، عرفت العائلة الهوان والفقر وأنّ أخيه “فريد” هو الذّي يعيلهم، أمّا الأخ الآخر “بوعلام” فبعد اختفاء “فيصل” أخذته الشّرطة لاستنطاقه واتهمته بالضّلوع في عمليات إرهابية وعندما لم يعثروا على أيّ دليل أطلقوا سراحه، ولكن “بوعلام” الذّي لم يستوعب فترة الاستجواب هذه قرّر ترك المنزل وغاب عن الأنظار ولا يعلم أحد لحدّ الآن أين يتواجد.
وعلم “فيصل” أيضًا بأنّ أخته “رزيقة” التحقت بالجامعة وهي تدرس الحقوق وربّما ستصبح مُحامية كبيرة، واندهش، حينها قال له والده:
“أنا الذّي شجّعتُ رزيقة على مُواصلة الدّراسة في الجامعة ورافقتها بنفسي يوم التّسجيل وتسليم مفاتيح الإقامة الجامعية. الدّنيا تغيّرت يا فيصل يا ابني. ودراسة البنات أصبحت من ضروريات الحياة. أنظر إلى حالتنا… بؤس على بؤس ولا أمل في التّغيير… الشّهادة الكُبرى تفتح العمل والمُستقبل لنا ولها…” (ص 84).
لم يعقب “فيصل” على كلام والده، ما كان يشغله هو حالة والدته، استدار من حوله ورأى وضعية البيت في خراب توجّه نحو الثّلاجة ووجدها بالكاد فارغة، نهض وقرّر الخروج لشراء بعض الحاجيات.
في مقرّ الشّرطة
عند خروج “فيصل بوسكّين”، جاء رجال الشّرطة إلى البيت وتركوا ورقة استدعاء، وبعد عودته أخبر والدته بأنّه مُجرد استخبار وخرج مُتجهًا نحو مركز الشّرطة.
استقبله مُفتش الشّرطة قائلاً:
“أهلاً بك الأخ بوسكّين… أنت الآن معنا وجزء منّا (…) فات اللي فات ونحن الآن أمام وضع جديد يُسمّى المُصالحة الوطنية، فلنتصالح إذًا وننسى الماضي، أنا استدعيتك لهذا الغرض، لأتأكّد من أنّك عُدت إلى أهلك سالمًا، ولأقول لك أنّنا هنا لمساعدتك، إنّ الشّرطة ذراع يحميك من أيّ خطر قد يُهدّدك (…) أعرف أنّك لم تكن تنتظر منا هذه المُعاملة بسبب ما جرى لك في السنوات الماضية. ولكن ثِق أنّ الدّولة الجزائرية تلتزم بوعودها في وضع حدّ لهذه المواجهة بين الجزائريين نهائيًا، وننتظر منكم المُساهمة الفعالة في استتباب الأمن وتمتين وثائق التّعاون بيننا لنغلق هذا الملف بصفة نهائية، وننتقل إلى مرحلة جديدة نُخصّصها لتطوير البلد وإخراجه من الأزمة التّي تخبّط فيها منذ سنوات” (ص 112-113).
“وأنا أيضًا قررتُ وضع حدّ فاصل بين حياتي الماضية وما ينتظرني من السّنوات التّي كتبها اللّه لي”، أجابه “فيصل بوسكّين” (ص 113).
“المُهم يا سي فيصل، نحن في الخدمة ولا تتردّد في الاتصال بنا عند أيّ مُشكل يعترضك (…) نصيحة قد تنفعك وتنفعنا يا سّي فيصل! إذا حدث أن اعترض سبيلك شخص ما، مهما كانت صفته، واستفزّك أو قال لك كلامًا غير لائق، فمن فضلك حافظ على هدوئك ولا تردّ عليه، لا بالمليح ولا بالقبيح. اتصلّ بنا ونحن نقوم بالواجب”، قال له مُفتش الشرطة (ص 114).
خرج “فيصل” من مقر الشّرطة، مُتّجهًا نحو البيت العائلي. لقد شيع الآن خبر عودته في كل القرية، وفي تلك الأمسية، سُمع صراخ يخرج من مسجد القرية:
“يا الذّباح… يا القاتل… يا المُجرم…” (ص 127)، إنّه صوت الشّيخ “السّبتي”، فماذا سيحدث يا تُرى؟ هل سينتقم من “فيصل بوسكين” ويُشفي غليله؟ وهل سيتجنّب “فيصل” وقوع ذلك؟ وهل سيتمكّن من استرداد أمواله كما وعده “مصطفى”؟
أين نحن من العُشرية السّوداء؟
ينقل “محمد ساري” القراء إلى فترة نهاية العشرية السّوداء وإصدار قانون “الرّحمة” في عهد الرّئيس الجزائري السّابق “اليامين زروال” الذّي أصبح قانون “الوئام المدني” في عهد الرّئيس الرّاحل “عبد العزيز بوتفليقة”، ولكن تساءلنا، لماذا استعاد الكاتب موضوع الإرهاب في الجزائر؟ هل يا تُرى يوجد الكثير ما لم يُقال بخصوص هذه المرحلة؟
طرحنا السّؤال على الكاتب فأجابنا أنّ الجزائر مرّت بعشرية مأساوية لم تكشف بعد عن كل أسرارها. فهو عاش تلك السنوات المرعبة وكانت الأخبار المؤلمة تنزل عليهم يومياً كالصواعق القاتلة. وكانوا يخرجون صباحًا ولا يعرفون إن كانوا سيعودون أحياء إلى ديارهم مساءً. وقائمة الاغتيالات والتفجيرات والاعتداءات والاختطافات والمواجهات بين عناصر من قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة تنشبّ في كل مكان. فمهما كُتب فلا يمكن أن يُكشف عن تفاصيل ذلك الرّعب. ويضيف أنّ مهمته ككاتب هو أن يكون شاهدًا على عصره الذّي يعيش فيه، بحيث كتب روايات عديدة عن هذه العشرية: الورم، القلاع المتآكلة، حرب القبور وجسدي المستباح (تحت الطبع بدار المتوسّط)، أمّا رواية “حصّاد الرّمال” فقد تمحورت حول مُخلفات العشرية السوداء. ويتساءل ماذا يحدث لإرهابي يعود إلى قريته بعد أن استفاد من قانون المصالحة الوطنية؟ ويقول إنّه سؤال مُحرج ويتفادى الجميع الخوض فيه لأنّ أسئلة كثيرة بقيت مُعلّقة ولا أحد يجرؤ على الإجابة عنها.
واختار “محمد ساري” بطلاً لروايته إرهابي سابق، ولكن لماذا هذا الاختيار؟ وما هي الرّسالة التّي يرغب في إيصالها؟
أجابنا الكاتب أنّ معرفة ماذا حدث لإرهابي نجا من العمليات الإرهابية التّي مارسها لسنوات وهو يعود إلى قريته وأهله يهمّه كثيرًا. لقد ارتكب جرائم قتل ونهب وتدمير ثم ها هو يستفيد من المصالحة الوطنية ويعود إلى الحياة المدنية. هل يُمحى هذا الماضي بجرة قلم، أم أنّ هناك جرائم لا تتقادم وتبقى حيّة نابضة في الأذهان. فهو كروائي يهمّه أن يتتبّع مسار فرد من هؤلاء ومعرفة موقفه مما ارتكب من جرائم. يهمّه معرفة الأسباب السياسية والأيديولوجية والاجتماعية والنفسية التّي حركّته لرفع السلاح وإعلان الحرب على الدولة والمجتمع، وحينما يستفيد من المصالحة الوطنية فكيف تكون نفسيته وكيف يعيش حياته الجديدة؟ كيف يعيش مع ذاكرته، ما موقفه من الجرائم التي اقترفها؟ هل يعيش تأنيب الضمير من جرائمه أم أنه يبرّرها ويجد لها مصوغات دينية وأيديولوجية ليريح ضميره. إنها مسألة أخلاقية ومسألة ضمير يعيشها آلاف الذين حملوا السلاح وشكلوا جماعات إرهابية سموها “إسلامية”، ويناقش “محمد ساري” حتى قضايا فقهية متعلقة بالجهاد وما يجره من قتل وسرقة ونهب.
الدولة الإسلامية
ويتساءل هل بناء “الدولة الإسلامية” يبرّر كل تلك الحرب والمجازر في حق المدنيين الأبرياء وسبي النساء واغتصابهن؟ إنها أسئلة حرجة ولا يزعم الكاتب أنّه يملك أجوبة قطعية لها، وإنما هي محاولة منه لقراءة تلك الحالات الاجتماعية اعتمادًا على حوادث حقيقية لأشخاص سمعها أو قرأها عنهم وبعضها يعرفها عن قرب. ورسالته هي أنّ ما حدث في تسعينيات القرن الماضي في الجزائر وما حدث في بقية البلدان العربية والإسلامية بحاجة إلى دراسة معمّقة لاستخراج الدّروس والاستفادة منها مستقبلاً. فالجزائر لم تجنِ فائدة من عشرية كاملة من العنف والاقتتال بين الجزائريين، وهنا لدى أفراد داخل المجتمع من لا يزال يؤمن بإمكانية نهج نفس الطّريق لحلّ مشاكل البلد والمجتمع. لهذا فإذا أردنا ألّا نقع في نفس الحرب المدمرة فما علينا إلا أن نستنتج الدّروس بعد دراسة ما وقع ومن جميع الأوجه: السياسية، الدينية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وكذا التاريخية.
واختار الأستاذ “محمد ساري” عنوان روايته تحت اسم “حصّاد الرّمال”، فهل من دلالة ما لاختياره عنوان كهذا؟
طرحنا السؤال على الكاتب فأجابنا أنّ العنوان استعارة للدّلالة على العقم. ماذا يمكن لحصّاد أن يجنيه من الرّمال؟ طبعاً لا شيء. الرّمال بطبيعتها لا تُنتج ثمارًا مثل التّراب الخصب. وقد اختار “محمد ساري” من قبل عناوين أخرى مباشرة قبل أن يستقر على هذا العنوان، حيث فكّر في عنوان “الغنيمة” ثم “الغنيمة الدّموية”، ولكن وجد فيه مباشرة، رغم التصاقه الشّديد بموضوع الرواية، ففضّل عنوانًا يجعل القارئ يتساءل عن معناه لما فيه من شعرية واستعارة.
المصالحة الوطنية
ومهما يكن الأمر، هل موضوع المصالحة الوطنية تمّ بالفعل بين كل أبناء الوطن أو أنّ الأمر لم يتم إلاّ شكليًا؟
أجابنا الكاتب قائلاً إنّ موضوع المصالحة الوطنية قيل الكثير عنه وقبلها عن قانوني الرحمة والوفاق الوطني، ويعترف أنّها مُبادرات إيجابية لوضع حدّ للعنف وسفك الدماء. ويقول إنّه كان على السّلطة في الجزائر أن تبحث عن طريقة لإيقاف الحرب الأهلية التي خلّفت، حسب الإحصائيات العديدة، أزيد من مائتي ألف قتيل، زيادة إلى ما تمّ تدميره من منشآت عمومية وخاصة، وتهجير آلاف العائلات من سكناتها، دون الحديث عن المفقودين والنّساء المُغتصبات والصّدمات النّفسية التّي خلفتها الأحداث. فكلّ الحروب تنتهي بهذه الطريقة، ويتمّ العفو العام عن جميع الأطراف المتسبّبة في اندلاع الحرب، ذلك أنّه يصعب تحديد المسؤوليات في ارتكاب الجرائم. ولكن لا يعني هذا أن نمحو تلك العشرية من تاريخ الجزائر ونعمل كما لو أن شيئًا لم يحدث. ويضيف أنّه لا يزال التاريخ إلى يومنا هذا يكشف جرائم بشعة ارتكبت في حروب القرن العشرين، بل وحتى في القرون الماضية مثلما حدث بعد الثورة الفرنسية، وكذا حرب التّحرير الجزائرية. لهذا تكمن مهمة الجميع في قراءة تلك الفترة بتروٍّ بحيث نستفيد من دروسها كي نتجنب الوقوع في وضعية مأساوية شبيهة بها. ويظنّ أنّ ما تفعله أوروبا في محاربتها لليمين المتطرف والفكر النازي والحديث عنها باستمرار في مجال السينما والرواية (باتريك موديانو مثلاً) لهو خير نهج ننتهجه إزاء الإرهاب والتّطرف الدّيني الذي عصف الجزائر في تسعينيات القرن الماضي وما زال يعصف دول عربية إلى يومنا هذا.
“حصّاد الرّمال” لـ “محمد ساري” هي رواية جريئة وتطرح الكثير من الأسئلة حول هذه الفترة السوداوية التّي عاشتها الجزائر، فلا تتردّدوا في اقتنائها!